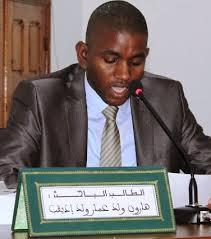مقاربة حول أساس المسؤولية الجنائية وعقوبة الطفل القاتل من خلال الشريعة والقانون.
دُونَ تَعَمُّقٍ؛...
ليس من الهيِّن أن نناقش مسألة جوهرية كمسألة المسؤولية الجنائية للطفل \ القاصر\ الحدث Le mineur \ L’enfant دون أن نعرض إلى الإشكال الأهم المطروح حول مبنى المسؤولية بصورة عامة. فإذا كان المُجرم هو لَوْلَبُ الجريمة ومُحرّكها وهو المسؤول الأول لكونه محل انطباقها، باعتباره المفكر والمحضر والمخطط لها والمنفذ لها اختيارًا أو اضطراراً حسب المنطلق الفلسفي، فإن السائد المستقرَّ أن المجرم لا يكون مسئولا عن أفعالهِ إلا إذا كان يتمتع بالقدرة على التفكير والإرادة الحرة، خاليًا من أي عارض ينفي عنهُ الصفة الإجرامية، بمعنى أدق أن الإنسان يكون أهلاً للمسؤولية عندما يكون ذا قوة نفسية من شأنها الخلق والسيطرة، وهي الإرادة المُعتبرة قانونًا، المُتجهة اتجاهًا مُخالفًا للقانون، أي "الإرادة الآثمة"، التي تجسِّد خطورة الجاني، الأمر الذي جعلها أساسًا للمسؤولية الجنائية، وتعكس هذا الضابط ثلاثة معايير: [السن؛ والاختيار؛ وخرق القانون] تجيز مُعاملة مُرتكب الفعل حينها كمُجرم.
إن أهم هذه المعايير هو السن لأنها محدد جوهري للمسؤولية الجنائية انطلاقا من التباين الجدلي الذي تعكسه النظريات الفلسفية الوضعية والعقدية الإسلامية التي تحاول الإجابة على التساؤل المُدوِّي (هل مرتكب الفعل مُخير أم مُسيَّر؟).
لقد تمخض عن هذا التفكير اتجاهان أساسيان تمَّ التوفيق بينهما فيما بعد، الأول يجعل أساس المسؤولية حرية الإنسان في الاختيار، وتقدير أعْمَالهِ المُختلفة التي يكون مسئولا عنها أخلاقيا ما دام قد فعلها اختيارا؛ فيعطي للمسؤولية الجنائية طابعا أخلاقيا لقيامها على الاختيار أي الحرية، والإدراك بمعنى التمييز (النظرية التقليدية)، والثاني يجعل أساسها الخطورة الإجرامية فالمسؤولية الجنائية لا تقوم على أساس أخلاقي في نظره، لأن الإنسان مُسيَّر وليس مُخيَّرا فإرادته ليست حرة لخضوعها لمؤثرات أقوى، منها ما هو كامن في شخصهِ، ومنها ما هو اجتماعي (النظرية الوضعية الجبرية)، وأمام هذا الجدل حاول البعض التوفيق بجعل حرية الاختيار أساسا للمسؤولية الجنائية لتسليط العقوبة كجزاء، فإن لم يكن ذلك الأساس موجودا، تسلط عليه تدابير احترازية لمواجهة خطورتهِ.
ونحن نؤمن ونسلِّم أن الإدراك والاختيار أهم أسس المسؤولية الجنائية ونرى من الثابت أن الإنسان يُولد فاقد الإدراك، ثم تدريجيًا بتقدُّم سِنِّهِ ونضج عقلهِ يتكامل إدراكه. لذا فإن السن كعاكس لذلك تبقى أهمّ أسس المسؤولية الجنائية.
لقد حددت غالبية التشريعات الحديثة سنًّا مُعينة للمسؤولية الجنائية، هي تمام سبع سنوات تأسيسًا على عدم إدراك الصغير لعواقب العمل الإجرامي ممَّا يمنحه قرينة غير قابلة للدَّحض على عدم قدرته على خرق القوانين الجزائية، وتصبح هذه القرينة بسيطة ابتداء من سبع سنوات [المواد: 2 ق ح ج ط الموريتاني، و94 ع أردني، 64 ع لبناني، 49 ع سوداني، 236 ع سوري، 18 ع كويتي]، وتتجه بعض التشريعات الأخرى إلى أزيد من ذلك وأقل من ثلاث عشر سنة كالمشرع الفرنسي، وفي كل الأحوال نجد أن تلك التشريعات تعاملت مع الجريمة المرتكبة من قبل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و15 سنة بمعاملة خاصة وأخضعتهم لإجراءات الحماية، بدل المعاقبة.
وقبلُ انطلقت الشريعة الإسلامية في تحدديها لأساس المسؤولية الجنائية من مبدأ الحرية والاختيار، وجعلت الأساس العاكس لهما هو بلوغ سن التكليف فلا مسؤولية جنائية على غير البالغ شرعا.
بيد أن طبيعة العقوبة في المنظومة الوضعية التي تعتمد أساسا العقوبة السالبة للحرية "السَّجنية"، فرضت اعتماد التجنيح، وتنصيف العقوبة في مجال الأحداث، غالبا ونادرا ما تسلط عقوبة الإعدام على الطفل القاصر، تختلف تماما عن طبيعتها في المنظومة العقابية الإسلامية التي تتنوع فيها العقوبة تبعا لتنوع غايتها [الوقاية، والنفعية] إلى عقوبات الحدود، والقصاص، والتعازير فهل يمكن أن تطبق هذه العقوبات وبشكل خاص الحدود والقصاص على الطفل القاصر غير المكلف أم لا وهل المعتبر لقيام المسؤولية الجنائية هو سن 18 سنة، أم أن المعتبر هو بلوغ سن التكليف بالمفهوم الطبيعي؟.
إن هذا لا يطرح أي إشكال في التشريعات الحديثة ذات الخلفية الوضعية لانطلاقها من أن أساس المسؤولية يعتمد على بلوغ الإنسان للسن القانوني الذي عينه المشرع وغالبا ما يكون 18 سنة، لكنه يثير جملة من التساؤلات في منظومتنا الجنائية ذات الخلفية الإسلامية الواضحة التي تعتمد الثلاثية الآنفة [الحدود، القصاص، التعازير] بالإضافة إلى تدابير الحماية الخاصة بالأحداث التي كرِّست لها مقتضيات خاصة، خصوصا إذا تعلق الأمر بجرائم القصاص والحدود والديات.
لقد اتفق فقهاء الشريعة على أنه يشترط لوجوب القصاص والحدود أن يكون الفاعل مكلفا أي بالغا عاقلا عند ارتكاب الفعل الجُرْمِيِّ. وأجمعوا على عدم شُمُول الحدود وكذا القصاص للطفل القاتل سواء قتل طفلا أو بالغا، يقول ابن عرفة "وشرط إيجاب القَوَد كون الجاني بالغا عاقلا"، وقد أطنب الشُّرَّاحُ والمُحَشُّون في ذلك عند قول خليل "بابٌ: إن اتلف مكلف وإن رُقَّ غير حربي ولا زائد حرية أو إسلام.."، وكذا عند قوله: "وعلى شريك الصبي القصاص إن تمالآ على قتله لا شريك مخْطئٍ ومجنون"، قال في الكفاف: الشَّرْطُ فِي القَوَدِ كَوْنُ المُجْتَرِي \ مُكَلَّفا وعِصْمَة المُتَبَّــرِ، وفي شرحه "وعمد الصبي والمجنون خطأ في مالهما إن كان وإلا ففي ذمتهما فإن بلغ عمدهما أو خطؤهما ثلث ديتهما أو دية المظلوم فأكثر فعلى العاقلة ومن يفيق أحيانا نظر لحاله حين جَنَى"، وقد أورد الحَطَّاب عند قول المصنف أنه يشترط في وجوب القصاص على القاتل ثلاثة شروط الأول أن يكون مكلفا وهو العاقل البالغ فلا قصاص على صبي ولا مجنون وعمدهما كالخطأ لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ وعن الغلام حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق" رواه أبو داود، وقد نبه الحَطَّاب إلى أن: "المرفوع في الحديث إنما هو الإثم وهو من باب خطاب التكليف وأما الضمان فهو من باب خطاب الوضع فالأول شرط فيه علم المكلف وقدرته بينما لا يشترط فيه العلم والقدرة فيضمن النائم ما أتلفه في حال نومه من الأموال في ماله وكذلك ما اتلف من الدماء غير أنه إن كان دون ثلث الدية فعليه وإن بلغ ثلث الدية فأكثر فهو على عاقلته، قال: وليس هذا بمعارض للحديث المذكور".
بيد أن الفقهاء اختلفوا في وضع معيار مطَّرد للبلوغ أو الإدراك، أو العقل أو التكليف أو الرشد،أو الحُلُم، أو الأشُدَّ، وإن اتفقوا على أن معنى تلك المتقاربات إن لم تكن في نظرهم مترادفات لغوية يختلف أحيانا مدلولها الفقهي دون مغزاها، فقالوا إن البلوغ قوة تحدث للشخص تنقله من حال الطفولة إلى حال الرجولة، وأن الإدراك الوصول والانتهاء إلى وقت التكليف، وأن التكليف إلزام المخاطب بما فيه كلفة ومشقة من فعل أو ترك، وأن الرُّشد حسن التصرف في المال والقدرة على استثماره واستغلاله استغلالا، وأن الأشُدّ طور يبتدئ بعد انتهاء حد الصغر من وقت بلوغ الإنسان مبلغ الرجال إلى سن الأربعين وقد حدَّه ابن عباس بثماني عشرة سنة وهي أقل ما فيه.
فنرى أن جميع تلك المدلولات المتقاربة أو المترادفة توصل إلى غاية ونتيجة واحدة هي البلوغ العاكس للتكليف، لكنهم اختلفوا في علامة حصوله الطبيعية كالاحتلام والحبل والحيض، كما اختلفوا أيضا في السِّن الدالَّة عليه عند عدم حصول العلامة الأولى، فرأى الجمهور [الشافعية والحنابلة و أبو يوسف ومحمد من الحنفية] أن البلوغ بالسِّن يكون عند تمام خمس عشرة سنة قمرية للذكر والأنثى، فيما رأى المالكية أن البلوغ يكون بتمام ثماني عشرة سنة وقد روى الحَطَّابُ خمسة أقوال في المذهب تحدد سنَّ البلوغ بـ: 17- 18- 16- 15- 19 سنة، وفرَّق أبو حنيفة بين الذكر والأنثى قائلا إن البلوغ بالسن للغلام 18 سنة والجارية 17 سنة.
إن هذا التباين الجلِيِّ في الفقه يمكِّننا من فهم التصور الإسلامي للإجابة على التساؤل الملِحِّ عن مدى تحديد سنِّ البلوغ، ومن ثمَّ فهل البلوغ الجسمي أو الجنسي الطبيعي هو المعيار للمسؤولية الجنائية، أم أن البلوغ العقلي هو أساسها.
والجواب بدون بَداهة هو أن سن التكليف أو الرشد الجنائي لا يمكن أن يكون تابعا للبلوغ الجسمي فقط. وأبسط دليل على ذلك أننا نرى في الفقه الإسلامي تلازمَ البلوغ مع العقل، ولذلك استثني المجنون الفاقد للعقل من المسؤوليات والتكليف الشرعي رغم بلوغه بدنيا وجنسيا لأنه فاقد العقل والرشد غير قادر على تمييز الأمور.
إن الإشكالية ناشئة من الجمع بين معياري: سن البلوغ الشرعي المعتبر في الأحكام العبادات، وسن الرشد العقلي المعتبر لقيام المسؤولية الجنائية، رغم أن القرآن أشار بصورة رائقة إلى الفرق بين البلوغ والرشد حيث يضع الرشد شرطا في صحة المعاملة المالية إضافة إلى شرط البلوغ قال تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ} [النساء: 6 ]، ففي الطبري وغيره أن المراد ببلوغ النكاح هو الحُلُم، وببلوغ الرشد العقل والصلاح فالآية دليل على أن الرشد خاص بالمسائل المالية والجزائية لأنها تؤكد على قضية الرشد وليس البلوغ في مسألة المال فإذا كان القرآن يؤكد على ضرورة الرشد عند الأطفال كشرط لتسليم المال فمن الأولى أن يكون الرشد معيارا للعقوبة أيضا فمعلوم أن حفظ النفس مقدم على حفظ المال شرعا وضرورة. وانطلاقا من هذا يمكن أن نجعل سنّ البلوغ 18 عاما معيارا لسن الرشد لقربه من السياق الشرعي العام وقواعد الشريعة الكلية، خصوصا مع تذبذب تحديد مدة الرشد المترددة في القرآن بين الأشد بمعنى الاستحكام والقوة البدنية والنفسية، أو سنِّ الأربعين سنة كما في آيات الأنعام: 53 والإسراء: 34 والأحقاف: 15، أو الشيخوخة كما في سورة غافر: 67، أو أهلية النبوة كما في سورة القصص: 4 ويوسف: 22. فمن خلال تتبع السياق القرآني نجد أنه حدد سنا معينا للرشد ولم يحدد سنا للبلوغ، فالبلوغ في القرآن يحتوي على عدد من المفاهيم والأعمار وغير محدد بسن معينة فهناك بداية البلوغ ولم يتطرق القرآن الكريم إلى تحديد سنه قال تعالى: {الَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ} النور 58، فالقرآن لم يحدد له عمرا معينا إنما أكد أن البلوغ شرط المسؤولية والتكليف، كما أننا لا نجد في السنة تحديدا واضحا لسن البلوغ وإن قيل سبعا وتسعا وعشرا، وهناك بلوغ الأشُدّ والذي يبدأ من سن 18 إلى 40 عاما، ونلاحظ تحديد القرآن له قال تعالى {حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً} قيل الأشد 33 سنة قال الطبري: "إن العرب إذا ذكرت مثل هذا من الكلام فعطفت ببعض على بعض جعلت كلا الوقتين قريبا أحدهما من صاحبه كما قال جلّ ثناؤه: {إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ}. إن هذا يوحي لنا بوجود نوعين من البلوغ بلوغ بدني غريزي ترتبط به التكاليف العِبَاديَّة، وبلوغ جسمي عقلي تربط به المسؤولية الجنائية وتكمل به الأهلية.
إن هذا الاستنتاج يتعزَّز بالواقع فالبلوغ يختلف حسب الواقع الجغرافي للإنسان فالأفراد الذي يعيشون في المناطق الحارة يصلون إلى سن البلوغ الجنسي قبل الأفراد الذين يعيشون في المناطق الباردة كما تذكر موسوعة BRITANNICA، ومنه نستنج بأنه لا يمكن تحديد عُمْر معين للبلوغ تابع للظروف الجغرافية والطبيعية بل لا يمكن تحديد سن معينة له حتى تكون قاعدة عامة تنطبق على الجميع وفي هذا نكتة عجيبة جعلت القرآن يتطرق إلى البلوغ فلا يحدد له سنًّا محددة بل يُوكِل أمر معرفة بلوغ الرشد إلى الأولياء عن طريق التجربة والابتلاء والاختبار.
لقد اتفقت الأمم اليوم على تحديد سنَّ 18 سنة كدليل مطرد على رشد الإنسان العقلي عندها يمكنه تحمل تبعات أفعاله ويكون مسؤولا جنائيا عنها، وهذا الاتفاق تجسده الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي تنص في مادتها الأولى على أنه: لأغراض هذه الاتفاقية، يُعْنى بالطفل أي إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه"، وتطبيقا لهذه المادة والمادة 40 من نفس الاتفاقية التي صادقت موريتانيا عليها وقامت بنشرها بالجريدة الرسمية [العدد 1326] نصَّت المادة الأولى من الأمر القانوني رقم: 015\2015 المتضمن الحماية الجنائية للطفل على أنه: يعتبر طفلا في مفهوم هذا الأمر القانوني كل إنسان يقل عمره عن ثماني عشرة سنة.
لقد ميَّز المشرع الوطني كغيره من التشريعات الحديثة بين ثلاث مراحل من مراحل القصور الجنائي MINORITÉ PÉNALE بحسب سنِّ القاصر أو الطفل:
مرحلة انعدام الأهلية تنعدم فيها المسؤولية العقابية وهي المرحلة التي تسبق سن السابعة [المادة: 2 ق ح ج ط].
مرحلة نقص الأهلية يكون ذا مسؤولية مخففة وتمتد من سن السابعة إلى سن الخامسة عشرة ويتم إخضاع القاصر لتدابير الحماية أو التربية.
مرحلة دنُوِّ البلوغ مع نقص الأهلية وتمتد من سن 15 إلى 18 يكون ذا مسؤولية ناقصة و يسمح عندها بتطبيق العقوبات المخففة في حقه على أن لا تتعدى نصف عقوبة البالغ [المادة:61- 63 ق ج، 147 ق ح ج ط] مع إمكانية التجنيح فيما عدا جناية القتل، [المادة:6 ق ح ج ط ] وأوجب المشرع تسليط تلك العقوبة في مؤسسة اعتقال خاصة بالقصر [المادة: 159 ق ح ج ط] مع إمكانية إعمال كافة البدائل عن الاعتقال كوقف العقوبة وغيره [المواد:170-171-172].
لكن الذي يشكل هنا هو أن المادة: 6 الآنفة تنص على عدم إمكانية تجنيح جناية القتل وحدها وفي نفس الوقت نجد المادتين: 60 و61 من القانون الجنائي تـنصَّان صراحة على أنه: "يحكم بالبراءة على المتهم الذي تقل سنه عن ستة عشر سنة ويثبت أنه تصرف دون تمييز... إذا ثبت أنه [الطفل] تصرف بتمييز [discernement] يحكم عليه بالعقوبات التالية: إذا استحق عقوبة الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة يحكم عليه بالحبس من عشر سنوات إلى عشرين سنة..." ثم إننا نجد [المادة: 147 ق ح ج ط ] تنص على أنه إذا كانت العقوبة المستحقة السجن المؤبد، فلا يمكن النطق بعقوبة تزيد على اثني عشرة سنة من السجن المشدد"، ورغم الفارق بين هذا النص وترجمته [Si la peine encourue est la réclusion a perpétuité Ile ne peuvent prononcer une peine supérieure a 12 ans de réclusion criminelle] إلا إننا نجزم أن هذه المادة تعني عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة les travaux forcés à perpétuité، التي تعتبر عقوبة جنائية بدنية مخلة بالشرف طبقا للمواد: 1-6- 7، من قانوننا الجنائي، ويؤيد هذا الفهم مدلول النسخة الفرنسية، فإذا راجعنا معنى réclusion criminelle في معجم DALLOZ القانوني \2010 نجد أن معناها حبس جنائي مع أشغال شاقة مؤبدة، بالإضافة إلى أنه لا وجود لعقوبة السجن المؤبد أو المشدد بهذا اللفظ في منظوماتنا الجنائية طبقا للمواد: 6-7 من القانون الجنائي كعقوبة أصلية Peine Principale منفردة، كما هو شأن أغلبية التشريعات اليوم كالتشريع مصري المادة: 14 معدلة، والجزائري المادة: 5، والمغربي الفصل 16، التونسي المادة: 5 من المجلة الجزائية، كما لا يمكن أن يتجه الفهم إلى أن المشرع استبدل الإعدام بعقوبة السجن المؤبد ثم قلَّص عقوبة السجن المؤبد إذا ما استحقت في حق القاصر إلى 12 سنة لأن هذا يجعل النص الخاص [147 ق ح ج ط] أكثر غموضا من النص العام [61 ق ج] وهو ما لا يعقل بل ينافي ما بين العام والخاص من تقييد. ذلك أن عقوبة القتل العمد هي القصاص \ الإعدام وليست السجن المؤبد أو السجن المشدد فبهذا تكون هذه المادة [147 ق ح ج ط] غير منطبقة على واقعة القتل العمد، وإن انطبقت على شيء إنما على عقوبة الأعمال الشاقة المؤبدة الواردة في المادة: 7 من القانون الجنائي، ويكون المشرع في هذا النص الخاص بالحماية الجنائية للطفل أهمل عقوبة القاصر القاتل "عمدًا" رغم أنه نص على أنها لا تقبل التجنيح بحَال [المادة:6 الآنفة]، ونصًّ على استبدال العقوبة المستحقة عندما تكون الإعدام بالسجن كعقوبة بديلة Peine alternatives في القانون العام طبقا للمادة :[61 ق ج]، ويبقى احتمال السهو أو سقوط كلمة الإعدام أو سوء الترجمة واردا ولا تسعفنا الأعمال التحضيرية لهذا النص في تبديد هذا الريب للأسف لعدم وجودها. لكن الإطلالة على التشريعات المشابهة تعزز هذا الاحتمال فعلى سبيل المثال قانون العقوبات الجزائري ينص في المادة: 50 على أنه: "إذا كانت العقوبة التي تفرض على القاصر هي الإعدام أو السجن المؤيد فإنه يحكم عليه بعقوبة الحبس من 10 سنوات إلى 20 سنة"، وفي المجلة الجزائية التونسية الفصل: 43 "يقع تطبيق القانون الجنائي على المتهمين الذين سنهم أكثر من ثلاثة عشر عاما كاملة وأقل من ثمانية عشر عاما كاملة. لكن إذا كان العقاب المستوجب هو القتل أو السجن بقية العمر فيعوض ذلك العقاب بالسجن مدة عشرة أعوام". وبناء على ما تقدم يكون المشرع أهمل في التشريع الخاص بالحماية الجنائية للأحداث رغم أنه قانون لاحقٌ عقوبة القاصر عندما تتعلق بجريمة القتل العمد أو القصاص.
إن العقيدة التشريعية الحديثة حول العدول عن عقوبة الإعدام في حق القاصر الجاني [المميِّز دون سن 18] المستحقِّ إلى سجنه كما هو سائد تعتمد أساسا على فلسفة الأعذار القانونية: وهي حالات محددة في القانون على سبيل الحصر يترتب عليها مع قيام الجريمة والمسؤولية إما عدم عقاب المتهم إذا كانت أعذار معفية، وإما تخفيف العقوبة إذا كانت مخففة" [المادة: 52 ع مصري]، والأعذار المخففة منها العام كصغر السن، الاستفزاز، ووقوع الجريمة إثر ثورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أثاره المجني عليه [المادة 277 ع مصري] و[61-62-297-298-302 القانون الجنائي الموريتاني]، ومنها الخاص المقرر في جرائم خاصة ومحددة مثلا أن يفاجئ الزوج زوجته وهي في حالة بالزنا فيقتلها هي وشريكها [المادة: 279 ع مصري]، وأما الأعذار المعفية هي التي تؤدي إلى عدم عقاب المتهم رغم مسؤوليته الجنائية [المواد:59- 166- 247- 411 ق ج موريتاني] ومعلوم ما بين الأعذار القانونية excuses juridiques ، والظروف المخففة circonstances atténuantes [437 ق ج موريتاني] من فروق.
ولاستنطاق ما أراد المشرع من وراء عدم التنصيص على عقوبات الحدود والقصاص المرتكبة من قبل الأطفال نجد أن المشرع الوطني اعتمد مقاربتين في مسألة المسؤولية الجنائية للقاصر دون سن 18 سنة:
الأولى: تنطلق من تحديد سن البلوغ بـ:18 سنة مع التركيز على التمييز، ومن هنا اتجه إلى حظر معاقبة الطفل الجانح بعقوبة تساوي العقوبة المقررة في حال البلوغ، تأسيسا على أن المقصود بالبلوغ إنما هو البلوغ العقلي الذي جعل له السن محددا لا بالبلوغ التكليفي الذي يثبت بالعلامات الطبيعية وعليه يكون الطفل في مفهومه في منأى عن عقوبة الإعدام والأعمال الشاقة المؤبدة والعقوبة السجنية الكاملة مع ملاحظة أن المشرع أهمل المرحلة الممتدة من 16 إلى 18 مكتفيا بالتفريق بين تصرفات الطفل المميز وغير المميز قبل سن 16 سنة وبهذا يكون متشبثا بمفهوم التمييز وعلاماته أكثر من التركيز على السن ومهملا للبلوغ التكليفي الطبيعي أي أنه يعتمد معيار الرشد العقلي بدل البلوغ التكليفي في تحديد سن المسؤولية الجنائية. ومن هنا أهمل الحديث عن الدية الشرعية التي جعلتها الشريعة على الضامن العاقلة \ أو الولي، مغلبا نظرية العذر القانوني، مقتنعا أن الطفل المميز دون 16 عاما مطلقا مسؤول لكنه متمتع بعذر مخفف، أما غير المميز فلا يمكن أن يحكم عليه إلا بالبراءة طبقا للمادة 60 من القانون الجنائي.
وهذه المقاربة اعتمدها المشرع في [الأمر القانوني رقم 162- 83 بتاريخ 9 يوليو 1983 المتضمن القانون الجنائي].
الثانية: تنطلق من عدم التفريق بين الطفل المميز وغير المميز فالقاصر في نظره كل إنسان يقل عمره عن ثماني عشرة سنة سواء كان مميزا أو غير مميز فإنه يعامل معاملة خاصة ولا يمكن بحال أن تسلط عليه العقوبة التي تسلط على البالغ اعتمادا على مبدأ تخفيف المسؤولية، وبهذا يكون المشرع قد حدد معيارا واحدا مطلقا ومجردا لأساس المسؤولية الجنائية هو بلوغ سن 18 سنة مطلقا، بغض النظر عن أي شيء آخر، مع تنصيصه على أن الطفل الذي لم يبلغ سن السابعة لا يمكن أن يساءل جنائيا، أما ما فوق ذلك ودون سن 18 سنة فيعتبر مسؤولا مسؤولية خفيفة حتى ولو كان عاقلا مميزا، وبالتالي يعتمد على العقوبة السجنية فقط في هذه الحالة دون الأخذ بمعيار البلوغ التكليفي أو التميّيِز العقلي كما هو الحال في القانون الجنائي العام. وهذه المقاربة يكرسها [الأمر قانوني رقم: 015\2005 بتاريخ: 05 \12\2005 المتضمن الحماية الجنائية للطفل].
إن هذا الإشكال يمكن تجاوزه بالجمع بين المقاربتين بواسطة التشبث بمعيار سن البلوغ 18 سنة كضابط للرشد الجنائي والتفريق بين الطفل المميز وغير المميز (دون السابعة) عند إعمال العقوبة التعزيرية ذات الطابع التأهيلي الإصلاحي واعتبار أن الطفل دون الثامنة عشر غير مكلف و ليس بعاقل؛ لأن التكليف والعقل متلازمان. فيكون لزاما الجمع بين عقوبة السجن على أن لا يتجاوز 20 سنة طبقا للمادة 61 ق ج، والدية الشرعية كتعويض عَما أتلف القاصر على المسؤول عنه لأن عمد الصبي وان كان خطأ إلا أنه يضمنه في ماله، أو يضمنه من يحرسه ولي أمره، وأما خطأ البالغ فتتحمله العاقلة لأن الأول من باب خطاب الوضع والثاني من باب خطاب التكليف، ثم تحديد سن القصور بـ 18 سنة وسن التمييز بـ7 سنوات فما فوق طبقا للمادة: 2 ق ح ج ط، ثم التفريق بين الصبي المميز وغير المميز في العقوبة التعزيرية لا في تبعات الفعل وضمانه، طبقا لمقتضيات المادة: 449 ق ج التي تحيل إلى الشريعة الإسلامية، وفي هذا مَنْدُوحَةٌ تمكننا من مسايرة الركب الدولي دون أن نخرج عن كلياتنا الشرعية الجامعة، وخروج من إشكال مستعص يلقي بنفسه على الأذهان رمت الإسهام في حله دون تعمُّق.
الدكتور: هارون ولد عمَّار ولد إديقبي - رئيس محكمة ولاية نواكشوط الجنوبية

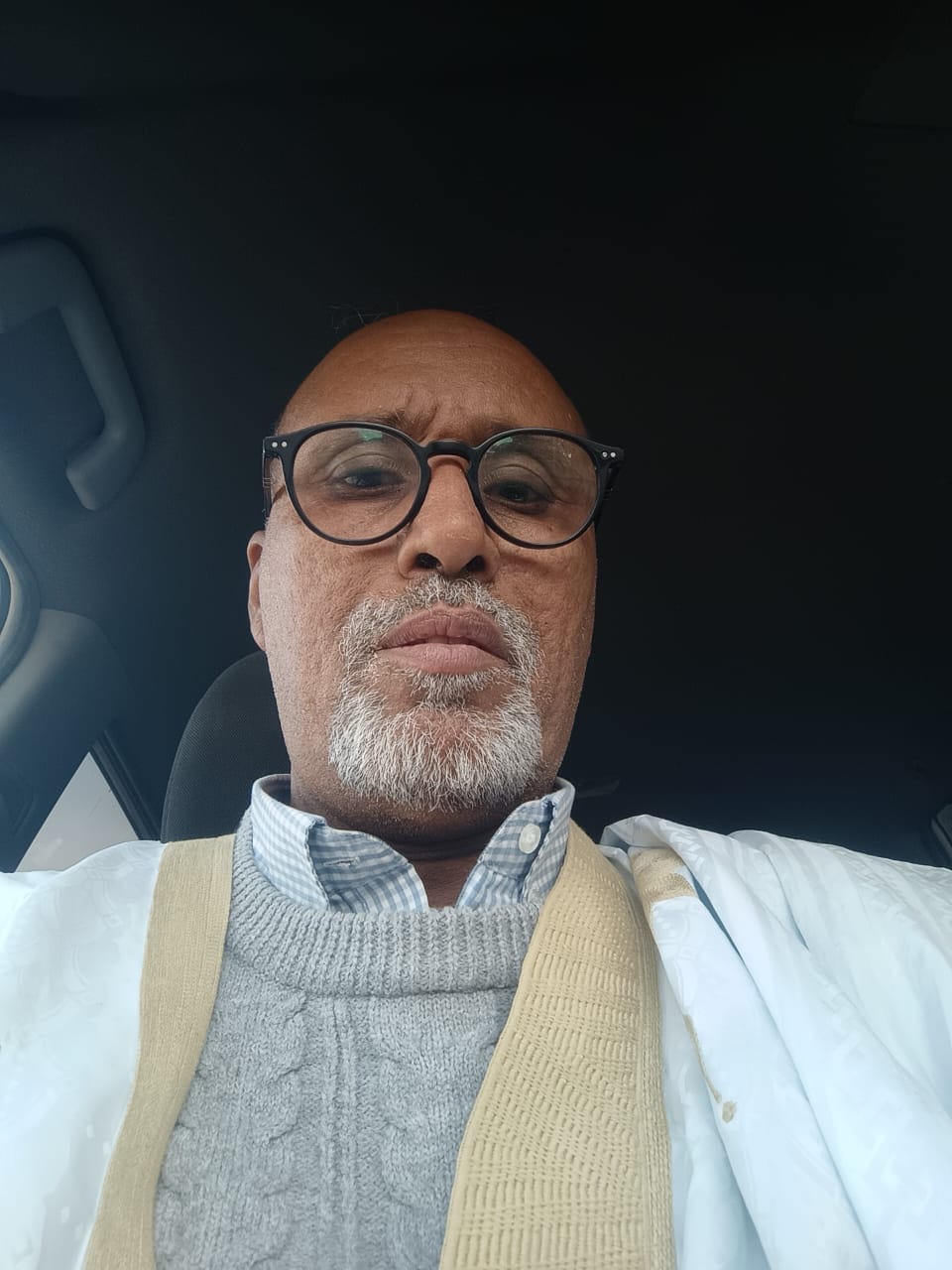



.jpg)